لا نجانب الصواب حينما نقول بأن التعليم كان معروفاً منذ القدم وقد كان الناس في تلك العصور يعتمدون في تعلمهم على المشافهة دون الكتابة من خلال تناقل روايات قصصية وحكايات فيما بينهم ، ومع تقدم الانسان واتساع مداركة وحاجته الماسة للتعليم لفهم ما يدور حوله في عالم الكون والحياة وما تقتضيه أحوالهم المعيشية والاجتماعية من تشريعات وتنظيمات للتمشي بموجبها لهدف تحقيق أهداف وغايات لا بد منها ، فقد شرعت بعض الأمم القديمة بإنشاء منظومات تعليمية وبمسميات مُختلفة ( دار ، زوايا ، كتاتيب ، مدارس ) للقيام بتدريس مواد مُعينة تتضمن تبصير أفرادها بأمور حياتهم وارشادهم لما يتوجب فعله لحمايةً أنفسهم ويخدم مصلحتهم العامة ، ومع نشأت الدول وانتهاجها لسياسات ودساتير مرجعية ، فضلاً عن فلسفات تربوية وتعليمية تؤمن بها فقد أصبح للتعليم شأن آخر على مستوى الحياة بعمومها ليتحول هذا التعليم بعدئذ من الاقتصار على المنهج التقليدي الذي يهتم كثيراً بالقراءة والكتابة والمحافظة على القيم الاجتماعية والتزود بشيء من العلوم والمعارف العامة إلى التركيز على إعداد جيل يُعتمد عليه في تحقيق ما تطمح إليه دولهم في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .هكذا أضحى التعليم قديماً والذي ما لبث أن تطور في وقت لاحق ليصبح قوة خارقة تفوق جميع الأسلحة التي تحرص جميع دول العالم على امتلاكها لكي تُحافظ على كيانها وعلى ممتلكاتها وعلى مواطنيها فكرياً وخلقياً ومسلكياً وتعدهم في ذات الوقت للحياة العملية وللدفاع عن وطنهم والمساهمة في رقيه وازدهاره ، وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدعوا لطلب العلم والنيل منه بشتى الطرق والوسائل من أجل تحقيق غايات كبرى لأعمار الأرض ، وبلادنا المملكة العربية السعودية وهي تدرك هذه الأهمية القصوى للتعليم لم تتوان ومنذ تأسيسها من القيام بإنشاء مدارس بمختلف مراحلها الدراسية الأساسية لحرصها التام على دخول التعليم لكل بيت في كافة مناطقها وهو ما تم فعلاً ، وفق خطط خمسية متواترة وليس هذا فحسب وإنما أيضاً تجاوزت ومن منظور هذا الحرص والاهتمام مرحلة التركيز على الكم إلى حيث التركيز على الكيفية والجودة في المخرجات بما يتوائم مع متغيرات الحياة وتحديات العصر. أما اليوم فإن التعليم في بلادنا واستناداً لرؤيتها 2030 م فنكاد نجزم بأنه سيصبح قوة مستدامة تضاهي به دول العالم ، وهو ما نعتقده صواباً للتخلي عن مختلف الطرق والوسائل التقليدية العقيمة المستخدم من قبل أكثر المعلمين والمعلمات داخل فصولهم الدراسية ممثلة في التلقين والحفظ والترديد ، فضلاً عن القوة التسلطية ، والاكراه ، والضرب المستخدم لدفع طلبة وطالبات المدارس للتحصيل العلمي والتي كان من نتائجها تسرب الكثير من الطلاب على وجه التحديد من مدارسهم على مدار عدة أعوام دراسية ماضية كما تبين ذلك من واقع دراسات وقفنا عليها في هذا الخصوص إبّان عملنا في مجال البحوث التربوية قبل عدة سنوات . أما عن أبرز ما تضمنته استراتيجية التعليم في بلادنا والمستوحاة من رؤيتها 2030م فهي كما يلي (1) بناء فلسفة المناهج وسياستها وأهدافها وسبل تطويرها وآلية تفعيلها وربط ذلك ببرامج إعداد المُعلمين وتطويرهم مهنياً بالإضافة للرفع من كفاءة أدائهم وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في منظومة العمل التربوي والتعليمي (2) الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المُتعلم والمُتعلمات محور العملية التعليمية وليس المُعلم أو المعلمات والتركيز على تعزيز القيم الخلاقة وبناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع والابتكار والقدرة على أتخاذ القرار لدى عموم الطلاب والطالبات (3) إيجاد بيئة مدرسية محفزة وجاذبة ومشوقة ومُرغبة للتعليم وإعادة صياغة مفهومها كمؤسسة تربوية وتعليمية تعمل على صقل المواهب وتنمية المهارات لأجل تخريج جيل ناضج وطموح ومقبل على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والإنتاج والمساهمة في متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل (4) تنظيم اللوائح والأنظمة والإجراءات ومنح الصلاحيات واعتماد التوجيه غير المركزي بما يكفل جدية العمل والانضباط في النظام ويعزز العدالة ويكافئ العاملين بناءً على عطائهم وتميزهم . بقي أن نشير في هذا الصدد إلى أن التعليم في بلادنا بل وفي غيرها من دول العالم لا سيما العربية منها وإن كان مُجدياً بطرقه وأساليبه القديمة والتي لاقت استحساناً وتأييداً من أولياء الأمور حين ذاك تحت مقولة : لكم اللحم ولنا العظم إلا أنه على هذا النحو لن يكون مُجدياً أو مقبولاً مع حاضرنا اليوم على الاطلاق ، وفي نفس الوقت علينا أن نفرق من زاوية أخرى بين استخدام هذه القوة لأجل دفع وارغام الطلاب والطالبات على الدراسة واستيعابهم لما درسوه لأجل تحقيق النجاح المؤمل دونما مراعاة لقدراتهم العقلية وهذا خطأ في التعليم ، وبين استخدام هذه القوة كوسيلة لاستقامة سلوكياتهم ومنعهم من الوقوع في المخالفات النظامية واللا أخلاقية ، فالقوة في التعليم إذاً مطلب حياتي وحضاري ومستقبلي وما سواه مدعاة للنفور والهروب وما يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها ، فدغدغة مشاعر الطلاب والطالبات والتأثير فيهم من الداخل من خلال استخدام كلمات مُحببة للنفس تحرك عواطفهم وتستميلهم لتلقي دروسهم بكل رغبة واشتياق أفضل وأنجع بكثير من تلكمً الضربات الموجعات التي تنهال على أجسادهم من كل ناحية أو التلفظ عليهم بكلمات بذيئة أو جارحة أمام زملائهم . جاء في الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خدمت النبي صل الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أفاً قط ، ولا قال لي لم فعلت كذا وكذا ، وفي رواية أخرى ، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته ، فلامني أو ضربني أو سبني أو عبس في وجهي . هكذا كان رسولنا الكريم ، وأسوتنا الحسنة صل الله عليه وسلم يتعامل مع الآخرين وفي تعليمهم أيضاً أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم كلما جالسهم أو خطب فيهم وبناءً عليه ، فإنه ما أحوجنا لهذا النهج السليم في كل منظوماتنا التربوية والتعليمية مع الأخذ بأسباب التحضر والتطور والتقدم التكنولوجي والتقني كقوة تعليمية وليس تعليم بالقوة.
بقلم / عبد الفتاح بن أحمد الريس
باحث تربوي وكاتب صحفي .
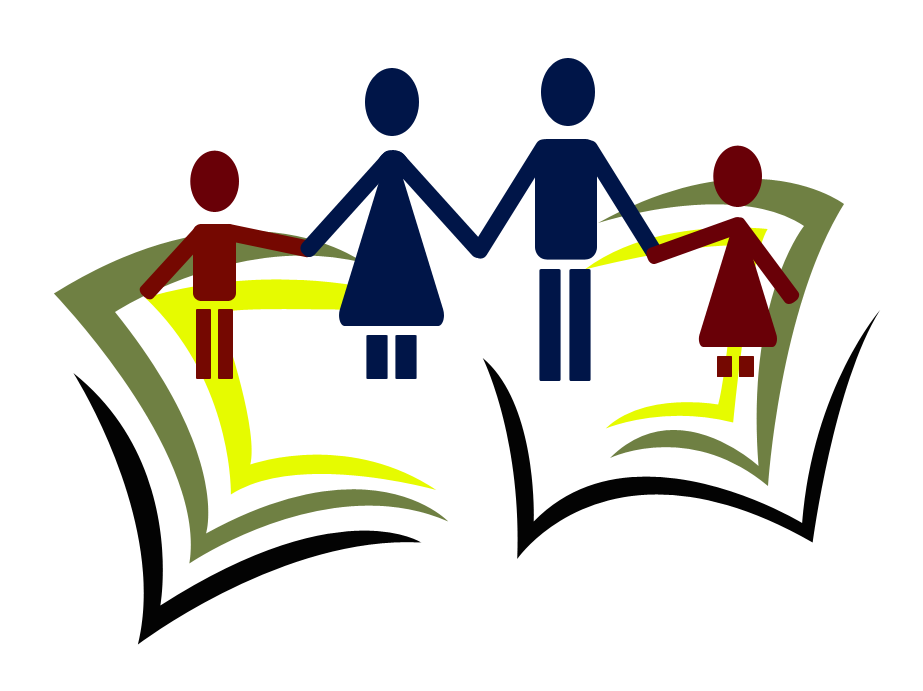

 (
( (
(


